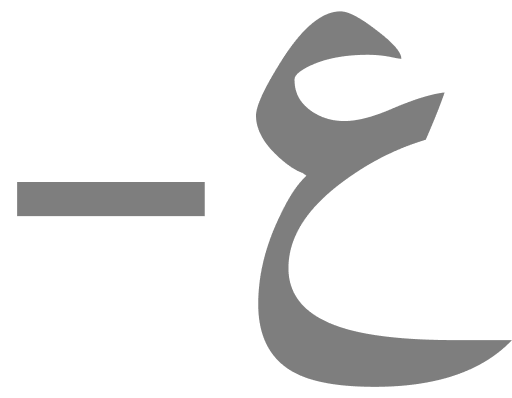اللغة العربية... رهان المستقبل
حذر أحد الباحثين في ملتقى ثقافي عربي من خطر انقراض اللغة العربية قبل نهاية هذا القرن، ولم يبدُ على أحد من الحضور أي قلق من هذا التحذير المرعب (لأن انقراض اللغة العربية يعني انقراض العروبة)! ولم يسأل أحد الباحث عن جدية إنذاره، وعن أدلة رؤيته، فقد كان الحضور على ما أحسب في أحد ثلاثة مواقف، أولها اعتبار هذا التحذير نوعاً من المبالغة بهدف إثارة الهمة للحفاظ على اللغة، وثانيها اعتبار موت اللغة العربية نتاجاً طبيعياً لتأثيرات عصر العولمة الذي استبدل بلغته الأم لغة عالمية هي الإنجليزية وقد باتت لغة السياسة الدولية والاقتصاد وكل أشكال العلاقات الدولية، وأما الموقف الثالث وكنتُ فيه، فهو الإحساس بالقلق الجاد أمام هذا التحذير، فقد طافت ذاكرتي سريعاً بالتاريخ، وتمثلت لي حالة بغداد مثالاً بعد سقوطها بيد المغول، فقد ضاعت الدولة التي كانت تتخذ اللغة العربية سياج سيادتها، وجاء عصر الدول المتتابعة الذي انتشرت فيه لغات الشعوب الوافدة والغازية، ولم يحفظ العربية من الضياع النهائي إلا القرآن الكريم. وقد باتت معرفة علوم العربية محصورة بالنخب، وأما عامة الشعب فقد باتوا أشباه أميين، وهذا ما يفسر غياب شعراء ومفكرين كبار عن مرحلة الدول المتتابعة بعد انهيار دولة الحمدانيين العربية التي أحس مفكروها بخطر الانهيار وفي ذاكرتنا صرخة أبي فراس المنذرة من خطر الضعف العباسي:
يا للرجال أما لله منتصف... من الطغاة أما للدين منتقم؟
ولقد تمكن الخدم من أن يصيروا حكاماً وملوكاً، وظهرت بعض دول غريبة عن العرب قبل سقوط بغداد، ومع وفرة ما نجد من مدوَّنات عربية ومعاجم في هذه المرحلة فإننا نلحظ نخبوية الثقافة التي تلاشت بالتدريج حين ضاقت النخب. وقد غابت اللغة العربية عن مسرح الثقافة في الأندلس مع سقوط دولة المعتمد، مثلما غابت في المشرق غياباً شبه كامل مع بدء المرحلة العثمانية، وإذن فقد يحدث انهيار للغة وغياب لحضورها، وهذا لا يعني أن لا نجد من يعرف العربية فسيبقى القرآن الكريم بوعد الله حافظاً لها، ولكنه يعني أن يضعف أدبها وفكرها وثقافتها، وفي سنوات الاحتلال الفرنسي المديد للجزائر، حافظ الشعب الجزائري على لغته العربية اليومية بفضل القرآن الكريم، ولكن الأدب بات نخبويّاً جداً، حتى إن الكُتاب المحدثين اضطروا إلى أن يكتبوا بالفرنسية لأنهم لا يعرفون الكتابة بالعربية، ولولا حرص الشعب الجزائري على دينه وعلى عروبته لانقرضت العربية من الجزائر. والخطر اليوم أن يحقق العرب بإرادتهم هزيمة للغتهم عجز عن تحقيقها أعداؤهم، ففي العديد من الأقطار العربية اليوم يتراجع حضور اللغة العربية دون أي ضغوط على الدولة أو على المجتمع، ودون أي منهاج مفروض للغة أخرى كما حدث في العهد العثماني حين أعلنت سياسة التتريك، فبعض العرب اليوم يهجرون لغتهم طواعية تقرباً من الغرب، ربما بدافع شعور بالدونية أمام الثقافة الغربية الطاغية.
وما يدفعني للكتابة في هذا الموضوع فضلاً عن التحذير الذي أثارني، ما أجده في لقاءاتي ببعض الإخوة العرب في لقاءات رسمية أو غير رسمية من إصرار على استخدام اللغة الإنجليزية، ليس في المؤتمرات الدولية التي تتاح فيها ترجمة إلى لغات أخرى فحسب، وإنما فيما بيننا نحن العرب، وقد شعرت بأسى حين زارني وفد عربي راح بعض أعضائه يتحدثون بالإنجليزية لأنهم لا يجيدون التعبير عن أفكارهم بالعربية، فتذكرت تحذير صديقي الباحث.
وأعتقد أن ما أعلنته قمة دمشق هذا العام من ضرورة الاهتمام بالعربية هو استجابة إيجابية للتحدي الذي تواجهه الأمة على الصعيد الثقافي، ومن المتوقع أن يجتمع وزراء الثقافة والتربية العرب جميعاً في دمشق قبل نهاية هذا العام لدراسة واقع اللغة العربية في التربية والتعليم والثقافة العربية، ولوضع برامج عمل للحفاظ على مكانة لغتنا ومستقبلها الحضاري.
ولئن كانت اللغة أهم أركان الشخصية الوطنية والقومية فإن ثمة معايير ثقافية أخرى جديرة بالاهتمام، منها التواصل والتكامل في المنتج الثقافي، فمن الواضح أن هذا التواصل ما يزال شكليّاً، ما دام الكتاب العربي لا يوزع في أرجاء الوطن الكبير، وما دامت نسخ الكتاب لا تزيد على ألفي نسخة في أغلب الأحوال، والأمر كذلك مع المجلات الفكرية والثقافية المتخصصة التي توزع في مناطق إنتاجها فلا تجد تواصلاً إلا لدى النخب من رواد المنتديات والمهرجانات العربية التي باتت وحدها فرصة اللقاءات والتواصل بين المنتدين.
وأما السينما والدراما التلفزيونية العربية فهما الأقدر على تحقيق تواصل ثقافي، ولكن السينما تشهد تراجعاً كميّاً ونوعيّاً، فلا تعرض الأفلام العربية على ندرتها إلا في المهرجانات التي تقام في العواصم وتغيب عامة عن الداخل، ولئن كانت الدراما التلفزيونية قد حققت انتشاراً كميّاً ونوعيّاً على الصعيد العربي، فإنها تعيش حالة عشوائية، فلم تدرس وسائل الإفادة منها للتنمية الثقافية ولمعالجة القضايا العربية الراهنة، لأن هذه الدراما تهدف إلى التسليّة وليس بين وظائفها تحقيق أهداف وطنية أو قومية إلا فيما ندر، مع أن الاستثناءات التي قدمتها هذه الدراما توحي بقدرة هائلة على تحقيق أهداف فكرية وثقافية. وبوسعنا أن نذكر المسلسلات التي استلهمت من التاريخ أو من الواقع معالجة لقضايا معاصرة، فحققت قبولاً كبيراً، وأثارت حوارات واسعة، ولكنها لم تجد رعاية رسمية توظفها لأهداف قومية، والأمر ذاته مع البرامج التلفزيونية التي بوسعها أن تسهم بقوة في صناعة المستقبل ولاسيما تلك التي توجه إلى الأطفال، وهنا أتذكر برنامج "افتح يا سمسم" الذي علم أطفال الأمة في الثمانينيات نطق اللغة العربية بلهجة موحدة ومحببة، ولكنه توقف، وليت الكويت الشقيقة تعود إلى إنتاج سلاسل من البرنامج متابعة عطاءها التربوي والثقافي المهم على صعيد الأمة مع أمنيتي بإعادة عرض ما تم إنتاجه منه لتقديمه إلى جيل من الأطفال جديد.
ولا أكتم القارئ إحساسي بالأسى لتحول التلفزيون العربي (الرسمي والخاص) إلى أداة تهميش للغة العربية بدل أن يكون أداة ترويج ونهوض، فإصرار الكثرة من العاملين في القنوات التلفزيونية العربية على التحدث بالعاميات المحلية يكرِّس حضور هذه العاميات، ويروِّج للكتابة بها بدل الكتابة بالفصحى، وبوسع التلفزيون أن يكرِّس اللغة الفصحى بمجرد أن تلتزم هذه القنوات بقرارات وزراء الإعلام العرب.
وثمة أمر أكثر خطراً هو عدم قناعة الكثرة من القائمين على التعليم العالي في الدول العربية بإمكانية التعليم العلمي باللغة العربية، وقد تحدثتُ عن هذا الموضوع عدة مرات وعرضت التجربة السورية الرائدة، ولا أجد مبرراً لنزعة التعريب في التعليم العالي، ولا أقصد بالتعريب استبعاد تعليم اللغات العالمية، لكنني لا أعرف أمة كبرى غير العرب تعلم أبناءها العلوم بغير لغتهم الأم، وهاكم الصين وروسيا واليابان وألمانيا وفرنسا وأمثالها من أمم الأرض، إنهم جميعاً يعلمون أبناءهم كل العلوم بلغاتهم القومية، ولم يمنعهم ذلك من تحقيق التقدم، ولم يعن حرصهم على لغاتهم القومية استبعاد الإنجليزية بوصفها لغة العصر.
إنني أجد أن العلاج الناجع لمشكلات الأمة على الصعيد السياسي هو في الحفاظ على التواصل الثقافي موازيّاً للتواصل الاقتصادي، بعيداً عن خصومات السياسة وانفعالاتها، فالضامن لوحدة الأمة ومستقبلها هو وجدانها المشترك، وفكرها وإبداعها، والضامن لبقاء هذا الوجدان حيّاً ومبدعاً هو لغتها التي تعبر عن هويتها وتؤكد حضورها بين الأمم.